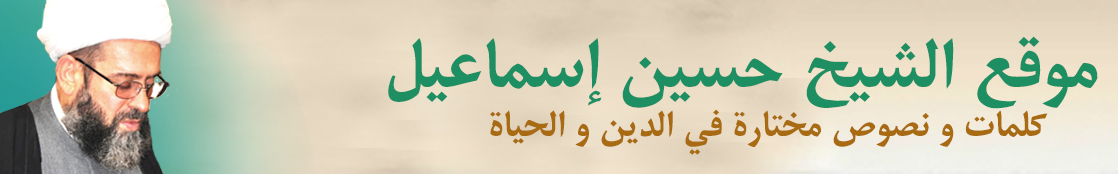الشيخ حسين إسماعيل : التقوى ومقياس التفاضل في الاسلام
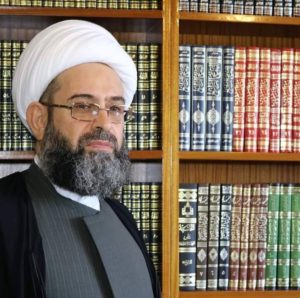
تحدث الله تعالى إلى الناس في القرآن الكريم فقال: بسم الله الرحمن الرحيم ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) [ الحُجرَات: 13].
تتضمن هذه الآية الشريفة جملة من الموضوعات الهامة، والتي تتعلق بعلاقة الناس بعضهم ببعض، وكيف ينبغي أن تكون هذه العلاقة سليمة ومستقيمة وتحمل الجميع على فعل الخير والصلاح، ونتحدث عن هذه الموضوعات من خلال العناوين التالية:
انفتاح الإسلام على جميع الناس
تبدأ الآية الشريفة بتوجيه خطابها إلى كل الناس من دون استثناء، قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ) والمقصود بالذكر هنا آدم (ع) وهو الأب الاول لجميع البشر، كما ان المقصود بالأنثى في الآية هي حواء زوجة آدم صلوات الله عليها وهي الأم الأولى لجميع الناس، والله تعالى يشير من خلال هذه الآية إلى أنه خلق جميع البشر على كثرتهم واختلافهم في اللون واللغة والأرض من أب واحد وأم واحدة.
ونسأل عن الحكمة من هذا الخطاب الرباني في الآية؟ وعن الهدف من ذكره ؟ الإجابة باختصار: هي أن الله تعالى ضَمَّنَ خطابه في الآية المتقدمة عدة أمور وهي:
أولاً: إنه تعالى خلقهم من نسب واحد يبدأون به، فرغم اختلافهم في الألوان واللغات والأرض، وفي ذلك دليل على عظمة الله تعالى في خلقه للبشر.
ثانياً: إن الله تعالى يذكر الناس من خلال قوله: ( إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ) بالرحمية المشتركة بين الناس على اختلافهم، التي تعكس أخوة حقيقية بينهم حيث ينتسبون إلى رحم واحدة، وهذه الأخوة تدعو إلى رفض منطق التكبر والتعالي بين الناس وتدفعهم إلى تحطيم الفوارق الطبقية التي تزرع الحواجز بين الإنسان وأخيه الإنسان.
ونستوحي من هذا النداء الإِلَهِيِّ في الآية المتقدمة أيضاً أن الله تعالى أراد أن يكون دينه الإسلام لكل الناس، ولا يختص نزوله باهل مكة أو بالعرب أو بالمسلمين بل هو رحمة منزلة لكل شعوب أهل الأرض، نعم لا يستفيد من هذا الدين إلَّا من التزم به وطبق تعاليمه عن عقيدة ثابته.
فالإسلام إذا منفتح على كل المجتمعات غير الإسلامية في الدعوة إلى الحوار والتعاون معها من أجل اصلاح الأرض ونبذ الظلم وارساء مبدأ العدالة عليها، ولا شكّ في أن هذا الأسلوب القرآني في الدعوة إلى الانفتاح على غير المسلمين يشكل قوة للإسلام تجذب غير المسلمين إلى طلب التعرّف عليه والاطلاع على مفاهيمه السامية وقيمه الهادفة وتعاليمه المضيئة بشرط ان يحسن المسلمون التعبير والخطاب عنها.
الإسلام والدعوة إلى التعارف بين شعوب الأرض
بعد أن ذكر الله تعالى بأن الناس يشتركون في النسب على اختلاف قومياتهم دعاهم إلى التعارف فيما بينهم وإقامة أفضل العلاقات، قال تعالى:( وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ) أشار الله تعالى في هذا الشطر من الآية إلى أن التقسيم الحاصل بين أهل الأرض إلى شعوب وقبائل إنما كان بأمر من الله تعالى، حيث ليس من الحكمة أن يكون كل أهل الأرض شعباً واحداً فالتنوع والانقسام يشكل ثروة ومصدر غنى للجميع، كما نستوحي هنا أن الله تعالى لم يذم القوميات فيما إذا كانت سبباً في شد أزر الناس بعضهم إلى بعض من دون ان تطغى على القيم الإنسانية والتعاليم الربانية، ومن هنا نجد ان رسول الله لم يَدْعُ إلى التنكر للأنساب، بل دعا إلى المحافظة عليها تحت عنوان الرحمية، إلَّا إنه رفض العصبيات المدمرة.
وأخبر الله تعالى بقوله: ( لِتَعَارَفُوا ) أنه أراد من الشعوب البشرية وقبائلها أن تتعرف بعضها إلى بعض بهدف التعاون على إصلاح هذه الأرض، كما أن الله تعالى لم يقيد التعارف في الآية باي نحو من الأنحاء فيكون تعارفاً اقتصادياً أو سياسياً أو دينياً وحسب بل هو تعارف يشمل كل النواحي الحياتية ويغني الجميع، ثم إن أهل الأرض يحتاجون إلى هذا التعارف حيث وزع الله تعالى في الأرض أقوات وحاجات البشر. ويشكل هذا التعارف جسراً لنشر رسالة الإسلام وتعريف المجتمعات الأخرى به، وهذا أهم أهداف التعارف.
الإسلام يرفض العصبيات القبائلية والشعبية
تقدم أن الله تعالى دعا إلى التعارف بين شعوب أهل الأرض وإلى إيجاد أفضل العلاقات فيما بينهم، لكنه تعالى رفض بالمقابل أن تتحول العلاقات القبائلية والشعبية إلى ميزان في التفاضل بين الناس جميعاً، بل يجب أن تكون هذه العلاقات محكومة للقيم التي هي أساس التفاضل بين الناس والتي هي قيم التقوى التي سنتحدث عنها فيما يأتي، كما أن العالم لن يعرف الاستقرار إلَّا إذا نبذت شعوبه العصبيات بمختلف أشكالها والتزمت القيم الأخلاقية والإيمانية، فالعرب لم يستطيعوا أن ينهضوا في بناء مجتمعهم إلَّا عندما تخلَوا عن العصبيات العشائرية، وهذا التخلي كان بفضل الإسلام وبفضل القيم التي جاهد النبي من أجل نشرها.
وورد عن الرسول الاكرم أحاديث كثيرة في نبذ العصبيات القبائلية وخاطب بها الناس في أكثر من مناسبة، فقد جاء في آداب النفوس للطبري أن النبي التفت إلى الناس، وهو راكب على بعيره في أيام التشريق بِمِنَى وهي الأيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة فقال: «يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود إلَّا بالتقوى، ألا هل بلّغت! قالوا نعم، قال: ليبلغ الشاهد الغائب» المتأمل في هذا الحديث يلحظ شدة اهتمام النبي (ص) بالدعوة إلى إلغاء العصبية وإبدالها بمقياس آخر وهو مقياس التقوى والطاعة لله. وورد عن النبي (ص) حديث آخر يقول فيه: «إن الله لا ينظر إلى أحسابكم، ولا إلى أنسابكم، ولا إلى أجسامكم، ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، فمن كان له قلب صالح تَحَنَّنَ اللهُ عليه، وإنما أنتم بنو آدم وأحبكم إليه اتقاكم» القرطبي : ج9 تفسير الحجرات.
مقياس التفاضل في الإسلام واحد ويشمل الأنبياء والمعصومين
تشير خاتمة الآية: ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) إلى حقيقة وهي أن مقياس التفاضل في الإسلام هو التقوى وهو مقياس شامل لجميع العباد، ولا يستثني أحداً منهم بما فيهم الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم، والدرجات التي حازوها عند الله إنما حازوها بفضل تقواهم واخلاصهم وحرصهم على صفاء إيمانهم وطاعتهم لله تعالى، وليس هناك أي مقياس آخر، ثم إن المتقين يوجد بينهم تفاضل على اختلاف مقاماتهم لأن تقوى الله درجات متفاوتة وكلما حاز المؤمن درجات أكثر تقدم في الفضيلة على غيره.
والتفاضل هنا يشمل الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم وهم درجات متفاوتة في تقوى الله تعالى، ولا يعني ذلك أن بعضهم يقع في المعاصي بل هم جميعاً مُنَزَّهُونَ عن ارتكاب المعاصي صغيرها وكبيرها، لكن المقصود بالتفاضل هنا هو التفاضل في ترك المكروهات وفعل المستحبات التي هي مشمولة بمفهوم التقوى في أعمق معانيها، إضافة إلى التفاضل بينهم في درجات اليقين بالله تعالى والصبر على النوائب.
ثم إنه من المستحسن عدم الدخول في موضوع التفاضل بين الأنبياء والأوصياء (ع) لأنه ليس من أحد مطلع على درجات الإخلاص واليقين لديهم أو هو محيط بتفاصيل حياتهم في صبرهم على البلاء والمصائب التي كانوا يتعرضون لها، وإذا جرى الدخول في موضوع التفاضل بين الأنبياء أنفسهم أو بينهم وبين الأوصياء فليكن من خلال الاعتماد على نَصّ قُرآنِيٍّ واضحٍ أو حديث صحيح السند وواضح المتن، لكي لا يقع الداخل في هذا الموضوع في بَخْسٍ أحدٍ من الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم، وخصوصاً أنه لا يستطيع أحد كما ذكرنا أن يطلع على بواطن الأنبياء والأوصياء ويعرف الدرجات التي تفاوتوا بها في يقينهم وإخلاصهم إلَّا الله تعالى، بل إن الدخول في التفاضل بينهم فيه مخاطرة كبرى لأنه غالباً ما يتضمن ذمّاً وتنقيصاً حيث التفضيل مدح وثناء للفاضل وقد يدفع هذا التفضيل بعض الناس إلى الذمّ والقَدْح في المفضول، وهذا فيه تجرؤ على الله تعالى وأنبيائه، وهو خلاف الأدب الواجب اثناء الحديث عنهم، فلذا كان الاحتياط يقتضي الابتعاد عن هذه المواطن. فالله هو المفاضل بين الأنبياء والأوصياء وليس البشر ( إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ) بدرجات تقواهم ( خَبِيرٌ ) بمستوى إخلاصهم ويقينهم.
ولا يخفى أن هناك رواياتٍ نُسِبَتْ إلى أهل البيت في إطار المفاضلة بينهم وبين غيرهم من الأنبياء وخاصة من أولي العزم صلوات الله على الجميع، وهي لا تصلح للاعتماد عليها لكونها ضعيفة السند ومن وضع الغلاة، وأهل البيت صلوات ربي عليهم اجمعين، ليس ادل على فضلهم وعلو منزلتهم عند الله من القرآن الكريم وما نزل في شأنهم من سور وآيات محكمات، كسورة الدهر الشريفة وآية التطهير وآية المودة وآية الولاية وآية المباهلة وغير ذلك من الايآت، فإنها تحتوي على إشارات هامة في الدلالة على عظيم منزلتهم عند الله تعالى ورفيع درجتهم.
ونؤكد انه ليس هناك من مقاييس أخرى عند الله غير تقواه، لذا من الغلو في العقيدة اعتماد غير التقوى في المفاضلة بين الأنبياء والأوصياء، ونورد هنا بعض الأحاديث الواردة لتأكيد أن التفاضل بالتقوى، ففي عيون الاخبار بإسناده إلى محمد بن موسى بن نصر الرازي قال: سمعت أبي يقول: قال رجل للرضا (ع) : والله، ما على وجه الأرض أشرف منك أباً وجداً، فقال (ع) : «التقوى شرفتهم وطاعة الله أحظتهم» فقال له آخر: أنت والله خير الناس، فقال (ع) له: (لا تحلف، ياهذا خير مني من كان أتقى لله تعالى وأطوع له، والله ما نسخت هذه الآية: ( وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ) » تفسير كنز الدقائق : ج 12، ص 340.
التقوى والابتعاد عن مواطن المعاصي
إن حقيقة التقوى تعني الابتعاد عن كل ما يؤدي إلى غضب الله والابتعاد عن رضاه، ومن هنا فالإنسان المؤمن يتقي غضب الله ويحرص على نيل رضاه من خلال الالتزام بأوامره تعالى والابتعاد عن نواهيه، وتحدث الله تعالى عن التقوى في كثير من الآيات كاشفاً عَمَّا لها من خصائص، وهذه بعض الآيات التي تتحدث عن التقوى: منها قوله تعالى: (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ) [ البَقَرَة: 197] فالتقوى خير زاد يأخذه معه الإنسان إلى الآخرة ويستعين به لمواجهة أهوالها. وقال تعالى: ( هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ) [ المدَّثِّر: 56] فمن حق الله على الإنسان أن يتقي الله ولا يعصيه، والله تعالى يكافئ المتقي بالمغفرة والتوبة.
وقال تعالى: ( أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى ) [ الحُجرَات: 3] التقوى تبدأ في القلب وبعد ذلك تشق طريقها إلى العمل. وقال تعالى أيضاً: ( وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10) ) [ الشّمس: 7-10 ] فالنفس البشرية لديها قابلية التقوى وقابلية الفجور إلَّا أنَّ لكل من التقوى والفجور أسباباً وعللاً فمن تمسك بالطرق المؤدية إلى التقوى يصل إليها ومن انحرف عنها يقع في الفجور. وورد عن الإمام علي (ع) كلمات في التقوى في غاية الأهمية لكونها تكشف عن حقيقتها وأسرارها، فقد جاء في نهج البلاغة أنه قال: «اعلموا عباد الله أن التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن ذليل لا يمنع أهله ولا يحرز من لجأ إليه وبالتقوى تقطع حمة الخطايا» نهج البلاغة : الخطبة 175، التقوى حصن لصاحبها من الوقوع في المخاطر والمهالك دُنْياً وآخرة.
إمام مسجد السيد عبد الحسين شرف الدين – قده – مدينة صور
الشيخ حسين إسماعيل